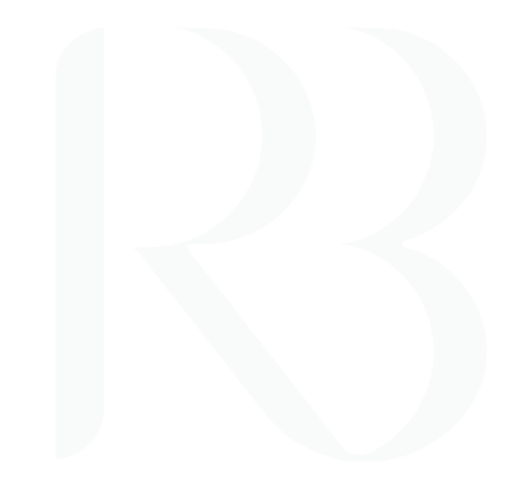إنتشال لبنان من عثرتها:
ما هي إمكانية وجود بديل واقعي لنظام المحاصصة الطائفية؟
عبدالرحمن عاطف أبوزيد
شهد لبنان تاريخ طويل من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، الى جانب تسجيله نسبة عالية من معدلات انعدام المساواة في توزيع الثروة على مستوى العالم، كما يواجه تحديات عدة تتعلق بإرتفاع معدلات البطالة والفقر وضعف الخدمات العامة والفساد، ومنذ اندلاع الازمة السورية، بات لبنان يواجه المزيد من التحديات التي يدفع ثمنها الاكثر فقراً. فالمناطق التي كانت تواجه النسبة الاعلى من انعدام المساواة في الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية، هي نفسها المناطق التي تستقبل الان النسبة الاكبر من اللاجئين السوريين: يتركز 67% من اللبنانيين المحرومين و87٪ من مجموع اللاجئين من سوريا في 251 منطقة، وبالمجمل يعاني 10% من اللبنانيين و52% من اللاجئين السوريين من الفقر المدقع.
وانتهى الامر الى انهيار الهيكل العام للدولة، رغم بقاء عنصريها الاساسيين وهما الشعب والارض، فان المهمة التي شكلت التحدي الاساسي بعد ذلك اليوم هي اعادة بناء الدولة، وإعادة استقرارها السياسي والاقتصادي مرة أخري، وبشكل عام فإن هناك قضايا أو مشكلات كبري يجب العمل على حلها بجدية، أولها، المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي والمصرفي والفشل في إيجاد الحلول، والمسؤولية عن انفجار أوتفجير مرفأ بيروت وثلث المدينة المنكوبة، ومسؤولية الدولة والحزب عن تسليم الكادر الحزبي المتهم بقتل الحريري للمحكمة الدولية، ومحاولة إيجاد نظام وقيادة سياسية مناسبة للمرحلة التالية.
وهنا يثور تساؤل متعلق باحتمالات بقاء النظام السياسي القديم القائم على المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية، حيث أن الاحداث في السنوات الأخيري أثبتت عدم قدرة النظام السياسي على تحقيق استقرار حقيقي للبلاد، وبالتالي فإن الواقع فرض النظر في بدائل واقعية مطروحة.
أولًا – أبعاد مشكلة عدم الاستقرار داخل لبنان:
أ- فشل نظام المحاصصة الطائفية في لبنان:
نصّ الميثاق الوطني الذي اعتمد مع استقلال لبنان في 1943 على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الحكومة مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وجرت الانتخابات التشريعية الأولى بعد الاستقلال عام 1947 واختار اللبنانيون 55 نائباً، بحسب توزيع طائفي قام على اختيار خمسة نواب مسلمين مقابل كل ستة مسيحيين، وبعد 15 عاماً من حرب أهلية مدمرة، نصّ اتفاق الطائف الذي تمّ التوصل اليه في 1989 ووضع حدّاً لاحقا للحرب على إلغاء الطائفية السياسية، لكن كثيراً من التسويات التي تضمنها، بالإضافة الى الممارسة الفعلية، رسخّت نفوذ الزعماء الطائفيين، ونصّ الاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف، لكن هذا المجلس لم يبصر النور بعد، وعمّق تنفيذ اتفاق الطائف الذي نصّ على المناصفة في المجلس النيابي بين المسيحيين والمسلمين، عمليا الطائفية في توزيع المناصب وأصبح ينسحب على كل الوظائف في الدولة. ولم يعد ممكناً تعيين أي موظف في منصب عال أو اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقة ممثلي المكونات الطائفية الرئيسية، وأدت الصيغة التوافقية إلى شلل الدولة. وباتت كل انتخابات رئاسية أو تشكيل حكومة مصدر أزمة سياسية جديدة، لضرورة التوافق على الاسم بين كل القوى السياسية الممثلة للطوائف في تسويات سياسية هشّة اعتادت عليها البلاد
تعتمد الديمقراطية التوافقية، على بناء التحالفات الكبيرة التي تضمن للمكونات الاساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى أسفله من دون الخضوع لسلطة الأغلبية؛ اذ تحتفظ الاقلية بحق النقض أو الاعتراض ما يجعل قدرتها على مواجهة الاغلبية وتجنب هيمنتها متاحة وممكنة على صعيد الممارسة وهو ما لاتتيحه الديمقراطية التمثيلية؛ لكن تطبيق "الديمقراطية التوافقية" ليس من الضروري أن نعتبر أن تطبيقه في لبنان معياراً لنجاحه أو فشله لعدة أسباب منها، غياب قانون الأحزاب، والرؤية السياسية الواضحة للحركات السياسية أو الافراد، ويختلف كثيراً عن دول الغرب في التطبيق على الأرض، فلم تعرف لبنان تجربة ديمقراطية حقيقية أو خبرة سياسية لدى الطبقة السياسية الموجودة أو المواطن الاعتيادي على حد سواء، وهذا أدى بالنهاية إلى الوقوع في فخ "وهم التعددية" .
وبالتالي، فإن استمرار هذه المحاصصات في كل شيء، بما فيها التعيينات، سيبقي لبنان في وضع هش ومشلول سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وسيبقي المؤسسات في لبنان رهينة للولاءات والمحاصصات الطائفية والحزبية، لذا على الحكومة التالية، أن تثبت أنّها تلتزم المعايير العلمية في التعيينات، بمعزلٍ عن الانتماءات السياسية، وأنّها تغلّب منطق الكفاءة على ما عداه، الأمر الذي يستتبع معه إعادة تنظيم الدولة اللبنانية على أسسٍ جديدة، تُلغي من قاموسها السياسي والاجتماعي المحاصصات الطائفية في تقاسم السلطة والنفوذ، من خلال تطبيق البند الدستوري الذي ينص على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ومنها يتم الانطلاق نحو وضع برنامج مرحلي، لتجاوز حالة الطائفية، وإعادة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح
ب- الفساد السياسي:
إن أهم أسباب عدم الاستقرار في لبنان هو نظام الحكم الفاسد، حيث يحكم لبنان ما بعد الحرب الأهلية نظام طائفي يهدف إلى موازنة القوة السياسية الموزعة بين الطوائف الدينية داخل البلاد، أي المسلمين السنة والمسلمين الشيعة والمسيحيين الموارنة والمسيحيين الأرثوذكس واليونان، كان الهدف من اتفاق الطائف لعام 1989، تحقيق التوافق بين الطوائف المختلفة، ومع ذلك، فإن نظام مأسسة الطائفية وتعزيز المحسوبية انعكس في عدم الاستقرار السياسي في لبنان اليوم.
على الرغم من تشكيل التحالفات والعمل معًا من أجل إدارة البلاد، فإن النخبة السياسية من كل طائفة تدعم وجودها واستمراريتها من خلال التجييش الطائفي، لأنه لا توجد طائفة واحدة تشكل الأغلبية داخل لبنان، ولأن ذاكرة الحرب الأهلية ما زالت حية بين العديد من المواطنين اللبنانيين، فإن النخب السياسية قادرة على تحفيز المخاوف من الأصوات وجلب الدعم، لقد تم التسامح مع المحسوبية التي روج لها هذا النظام عن غير قصد لأن المجتمعات شهدت بعض الفوائد من دعم ممثليها في السلطة، ومع ارتفاع وتيرة الازمة الاقتصادية، حيث فقد الناس إمكانية الوصول إلى أموالهم الخاصة المحتفظ بها في حسابات مصرفية بالدولار الأمريكي، وحيث أثبتت الحكومة الفاسدة أنها غير قادرة على التعامل مع حرائق الغابات، وحيث أخذت الجهود المبذولة للتصدي للمخالفات الاقتصادية شكل ضرائب على خدمة الواتساب، فكانت كل هذه التداعيات سببا كافيا لاهتزاز الإيمان بالنظام الطائفي وارتفاع منسوب الازمة السياسية أكثر.
وأسقط انفجار مرفأ بيروت المشروعية السياسية والأخلاقية عن النخب اللبنانية، ووضع النظام الاجتماعي والسياسي أمام تحدٍّ غير مسبوق، بعد أن كشف هشاشته وارتهانه للطائفية السياسية التي تغذّيها تحالفات الزعامات السنية والشيعية والدرزية والمسيحية مع القوى الإقليمية التي ترى في استمرار الوضع اللبناني على ما هو عليه حمايةً لمصالحها المختلفة، وقد لا يكون من المبالغة القول إن نظام المحاصصة الطائفية الذي أرسي سنة 1943 قد استنفد كل موارده التي ظل يحتكم إليها، ولم يعد له ما يقدّمه للبنانيين غير الخراب والفوضى وعدم الاستقرار، أكثر من ذلك، وساد شعور في لبنان أن الاستمرار في إعادة إنتاجه جريمة بحق الشعب اللبناني، المتطلع إلى تغيير حقيقي.
الأزمة الاقتصادية هي، في جوهرها، أزمة حوكمة مُنبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل بُنيوي، بما حال دون صنع سياسات عقلانية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر، وقد عاشت البلاد، وفي مقدّمتها القطاع العام، بقدرات تتجاوز إمكاناتها، وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج، كانت النتيجة اقتصاداً شديد المديونية، وقطاع مصرفي منتفخ وهش؛ كما جعلت الاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة البلاد عرضة إلى التأثُّر بالصدمات الخارجية والإقليمية، ومع تباطؤ التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، اضطُرّ مصرف لبنان إلى بذل جهود يائسة وباهظة التكلفة للغاية من أجل استقطابها، وفي نهاية المطاف، ثبُت أنها هذه السياسة المالية غير مستدامة.
ويكون بذلك قد أخفق أمراء الطوائف في اختبار الاندماج الوطني، بسبب ارتهانهم لأجنداتٍ خارجيةٍ، حولت لبنان ساحةً للحروب بالوكالة، وتصفيةِ الحسابات الإقليمية والدولية، وعجزوا عن بناء هوية وطنية جامعة، تستوعب الهويات المذهبية والطائفية التي أنهكت لبنان، واستنزفت رصيده الثقافي والحضاري ، كما كشف الحادث المروّع حجم الفساد المتوطّن في مختلف مؤسسات الدولة.
ج- تضارب المصالح للقوي الخارجية داخل لبنان:
على مر عقود، كانت النخب الحاكمة اللبنانية مرتبطة سياسيًا واقتصاديًا بقوي دولية وإقليمية عديدة وغالبًا ماكان يحدث خلافات لتضارب مصالح تلك القوي، مما يؤثر – غالبًا بالسلب - على سير العملية السياسية والاقتصادية في لبنان، ونستعرض من تلك القوي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، على النحو التالي:
1- الولايات المتحدة الأمريكية:
أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه لبنان تتمحور حول تأكيد استقرار الحدود بين لبنان وإسرائيل، ليس بالضرورة عبر اتفاقية سلام، بل استقرار يشبه الاستقرار الحدودي الذي منحه الأسد لإسرائيل على مدى أربعة عقود، ثانياً، تعتقد واشنطن أن "حزب الله" يشارك في هجمات حول العالم، مثلما حدث في بلغاريا، وفي معارك عسكرية خارج لبنان، مثل العراق أو اليمن، وهو ما يعني أن لبنان يستضيف منظمة عنفها عابر للحدود اللبنانية، ومن المهم لواشنطن وقف هذا الأمر، في الغالب عبر الحوار مع طرف قادر على السيطرة على الحزب؛ في الماضي، كانت واشنطن تكلف الأسد بذلك، وفي زمن الرئيس السابق باراك أوباما، تعاملت أميركا مع إيران لضبط "حزب الله" ومع "حزب الله" عبر وسطاء أمنيين لبنانيين، أما اليوم، في ظل تدهور العلاقة الأميركية مع إيران وضعف الأسد، المرشح الوحيد لضبط "حزب الله" هو دولة لبنان وجيشه، وهو ما يدفع واشنطن لدعم الجيش مادياً ومعنوياً، والى التمسك بدولة لبنان ومحاولة تعزيز سيادتها الى أقصى حد ممكن.
وتؤكد واشنطن على ضرورة تأمين مخازن الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تمثل تلك القضية أهمية للأمن اللبناني لأنه بإمكان تسريب هذه الأسلحة إلى «حزب الله» في لبنان ؛ ويمكن وقوعها أيضاً في أيدي متشددين في سوريا، حيث تكمن الخطورة في قيام هؤلاء المسلحين بنقلها إلى المسافرين في لبنان الذين يشاركونهم الأيديولوجيا نفسها، ويأتي ذلك من قلق أمريكا من أنه يمكن لذلك أن يُشعل مخاطر الفوضى في لبنان ويفضي إلى تصعيد آخر مع إسرائيل.
2- فرنسا:
تتمتع فرنسا بتاريخ طويل من التدخل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والثقافي وحتى العسكري في لبنان ، وقد أعلنت منذ فترة طويلة عن رغبتها في حل عدم الاستقرار الناتج عن الانقسامات الطائفية العميقة في لبنان، وتقدم باريس بشكل عام انخراطها الدبلوماسي المكثف في لبنان على أنه نابع بشكل أساسي من الارتباط العاطفي والتاريخي الذي تربطه فرنسا بلبنان وشعبه، كما أكدت فرنسا اهتمامها بلبنان كجزء من تصوراتها الجيوسياسية الأوسع للشرق الأوسط، حيث تعتقد أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر على الأمن الفرنسي؛ وأعلنت فرنسا مرارًا أن أهدافها في لبنان تتمثل في إرساء الاستقرار والحفاظ عليه، ودعم سيادتها، ومنع التدخل الخارجي في عملها الداخلي.
اتبعت فرنسا سياسة استرضائية تجاه حزب الله، فعلى سبيل المثال، بعد اكتشاف ستة أنفاق هجومية إرهابية بناها حزب الله في ديسمبر 2018 ويناير 2019 ووصلت إلى عمق الأراضي الشمالية لإسرائيل، قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شجبت فرنسا حفر الأنفاق، لكنها حافظت على موقفها التقليدي “كوسيط محايد”؛ وفي سبتمبر 2019، طالب ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، بضبط النفس الإسرائيلي في رد فعلها على هجمات حزب الله حتى لا يقوض استقرار لبنان؛ إن سياسة الاسترضاء التي تنتهجها فرنسا، كما يتجلى في مشاركتها الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي ، كانت لها نتيجة تتمثل في تشجيع حزب الله بدلاً من تثبيطه على مواصلة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل، وهذا يقوض أي فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان؛ ويوجد مشكلة مركزية أخرى في سياسة فرنسا تجاه حزب الله وهي معارضتها المستمرة لتصنيف الجناح السياسي لحزب الله كمنظمة إرهابية، ومنعت فرنسا محاولات الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا التصنيف وفرض عقوبات وفقًا لذلك، كما فعل الاتحاد الأوروبي سابقًا مع الجناح العسكري لحزب الله.
ثانيًا – سبل معالجة النظام السياسي في لبنان:
أ- المعالجة الداخلية:
منذ التعقيدات التي صاحبت تشكيل الحكومة اللبنانية المستقيلة، كما كل الحكومات السابقة، حيث إن كل المؤشرات تدل على أن المعضلة الأساسية في لبنان الشقيق هي لبنانية - لبنانية، أي أن المعضلة والتحدي الكبير والعسير الذي يواجه لبنان هو أساساً من الداخل بسبب تشرذم القوى والطوائف السياسية وسباقها المحموم نحو القيادة والزعامة الطائفية أو الدينية تحديداً.
كان واضحاً انهيار مقوّمات الدولة المدنيّة في لبنان وتلاشي قيم التعددية السياسية والدينية، وهو الثمن الذي يدفعه هذا البلد شعباً ووطناً اليوم، وهذا يعني أن من الواجب إدراك أن لبنان بحاجة الى إغاثة سياسية من الداخل وبدعم دولي وإقليمي؛ واستكمالًا للقرار الجريء بالتنازل عن سلطة الزعامة كخطوة أولى ليستعيد لبنان أنفاسه ويلتقط حواسه من أجل الخروج من الوضع المتآكل للبلد، وبالتالي إفساح المجال لعودة الدولة المدنية بأياد لبنانية بعيداً من صراعات المقاعد الحكومية والرئاسية.
ومن المهم توضيح أن مسألة صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، يتطلّب توزيع الخسائر على نحوٍ يتركّز قدر الإمكان على تجنب صغار المودعين وإلقاء وزرها على كاهل الأشخاص الأكثر ثراء في المجتمع. وفي هذا الصدد، من شأن التمويل الخارجي أن يساهم في تخفيف عبء التعديلات المطلوبة، كما لابدّ من إنشاء شبكة أمان لمكافحة الفقر ودعم الخدمات الصحية والتربوية، إضافةً إلى الحاجة إلى مساعدة العمّال في الانتقال من القطاعات المترهلة إلى تلك التي تستفيد من تراجع سعر الصرف
واتضحت تلك الرغبة في الإصلاح، كاستجابة للاحتجاجات في لبنان 2020، حيث اجتمعت الحكومة في "بعبدا" خلال شهر يونيو، وصدر في ختام اللقاء بيان أكد أن الاستقرار الأمني هو أساس و شرطٌ أساسي للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى، فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة؛ ودعا المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً للإرهاب.
ب- المعالجة الخارجية:
إنطلاقًا من أن لبنان هي منطقة استراتيجية ومنطقة لتقاطع المصالح للعديد من القوي الكبري علي رأسها فرنسا وأمريكا وإيران وغيرها من القوي الإقليمية، فإن ضمان الاستقرار داخل لبنان مرهون بعدم معارضة القوي الخارجية المعنية، وانطلاقًا من حقيقة أن المصالح الدولية نسبية ومن الصعب أن تلتقي في محور واحد، فلكل دولة مصالحها، فإنه من مصلحة الجميع التوصل إلى حلول وسط والجلوس على طاولة المفاوضات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وبالتالي يقع على عاتق أعضاء الأسرة الدوليّة، بما يشمل الدول والمنظمات الدوليّة والمؤسّسات الماليّة، الاضطلاع بدورٍ أساسيّ في الحدّ من الضغوطات الماكرو اقتصادية التي عصفت بالداخل اللبناني، والمشكلة الاقتصادية يكمن حلها بشكل أساسي وكخطوة أولي في تحقيق الاستقرار السياسي، فعلى الصعيد السياسيّ، يمكن للقوى العالميّة والإقليمية، أن تمارس تأثيرها وتوفّر الأمان السياسي والدبلوماسيّ الّذي من شأنه أن يشكّل أساسًا لخطّ المسار نحو النهوض الاقتصادي، عبر استخدام الدبلوماسيّة الرفيعة المستوى بهدف تقريب وجهات النظر فيما خصّ الحاجة إلى ضمان استقرار البلد ولا سيّما على ضوء التواجد الكثيف للاجئين السوريّين في لبنان؛ حيث أن أيّ تزعزعٍ للاستقرار في لبنان قد يدفع باللاجئين إلى التوافد بأعدادٍ كبيرة باتجاه حدود بلدان أخرى في العالم.
ويبدو أن العديد من فواعل المجتمع الدولي، تؤيد ذلك، فمثلًا، خلال شهر ستمبر الحالي، دعا مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلي بذل جهود دولية لمساعدة لبنان في تحقيق التقدم في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وقال بأنه يجب بذل الجهود لتهيئة ظروف مواتية للعملية السياسية في لبنان، وأن يهيء المجتمع الدولي مناخًا جيدًا للحوار الشامل، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، مع اتخاذ مجموعة الدعم موقفًا محايدًا ومتوازنًا.
وحيث أن لبنان هي بلد فقير الموارد ويعتمد على الاستثمارات والمساعدات الخارجية بشكل أساسي، فإنه من الصعب عليه أن ينعزل ويكتفي ذاتيًا على نفسه، بعيدًا عن الدول الكبري والقوي الخارجية الدولية والإقليمية، ومن ثم يجب أن يأخذ المجتمع الدولي ذلك بعين الإعتبار، وأن تحقيق استقرار لبنان لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي ومحاولة إقصاء المصالح الشخصية قدر الإمكان.
ج- إعادة هيكلة النظام السياسي:
طالب المحتجون في لبنان قبلًا، بتغيير جذري وإسقاط الدولة الطائفية التي يبدو أن الجميع يتفق على التخلص من المحاصصة الطائفية كمدخل لإصلاح شامل للدولة وإصلاح الدولة الوطنية المدنية، وذلك سعيًا لتحقيق الصالح العام، مع العلم أن مصطلح الشأن العام غير واضح أو محدد ولا يمكن تحديده إلا في ضوء الهندسة السياسية والتشريعية للمجتمع اللبناني.
ولما كان استغلال السلطة هو السبب الرئيسي لتفشي الفساد السياسي، حيث في ظل وجود مجتمعات متعددة لايوجد تجانس بالاضافة إلي التعارض في المصالح الخاصة بالدول الإقليمية والدولية في التوازن ممايحتم وجود "الديمقراطية التوافقية"، خاصة مع وجود في كل طائفة نخبة غنية وجماعات فقيرة، وتلك النخب مصالحها مرتبطة بدعم القوي الخارجية، والتي تحقق مصالحها بدورها هي الأخري عن طريق ذلك الحكم النخبوي.
ونحن نتفق مع رأي الخبير السياسي محمد عبدالهادي قفشي، بأنه ينبغي اعادة هيكلة النظام اللبناني مع اتفاق اقليمي ودولي إلى جانب تخفيف الضغوط الإقليمية التي تحيط بالحدود اللبنانية مثل خفض تهديد الكيان الصهيوني، ومن المهم أيضًا توافر إرادة قوية لمكافحة الفساد المستشري في الداخل السياسي اللبناني خلال مرحلة الإصلاح السياسي.
وبالتالي يمكن استبدال الديمقراطية التوافقية بديمقراطية تمثيلية، مع وجود إشراف دولي يمكن ان يتم تضمينه من خلال بعثة للأمم المتحدة، لضمان إنفاذ القانون علي الجميع بشكل متساو، ويضمن حقوق الأقليات وكافة الطوائف، وسيكون ذلك بالتزامن مع تعديلات دستورية تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب قدر الإمكان الابتعاد عن النظام السياسي الطائفي.